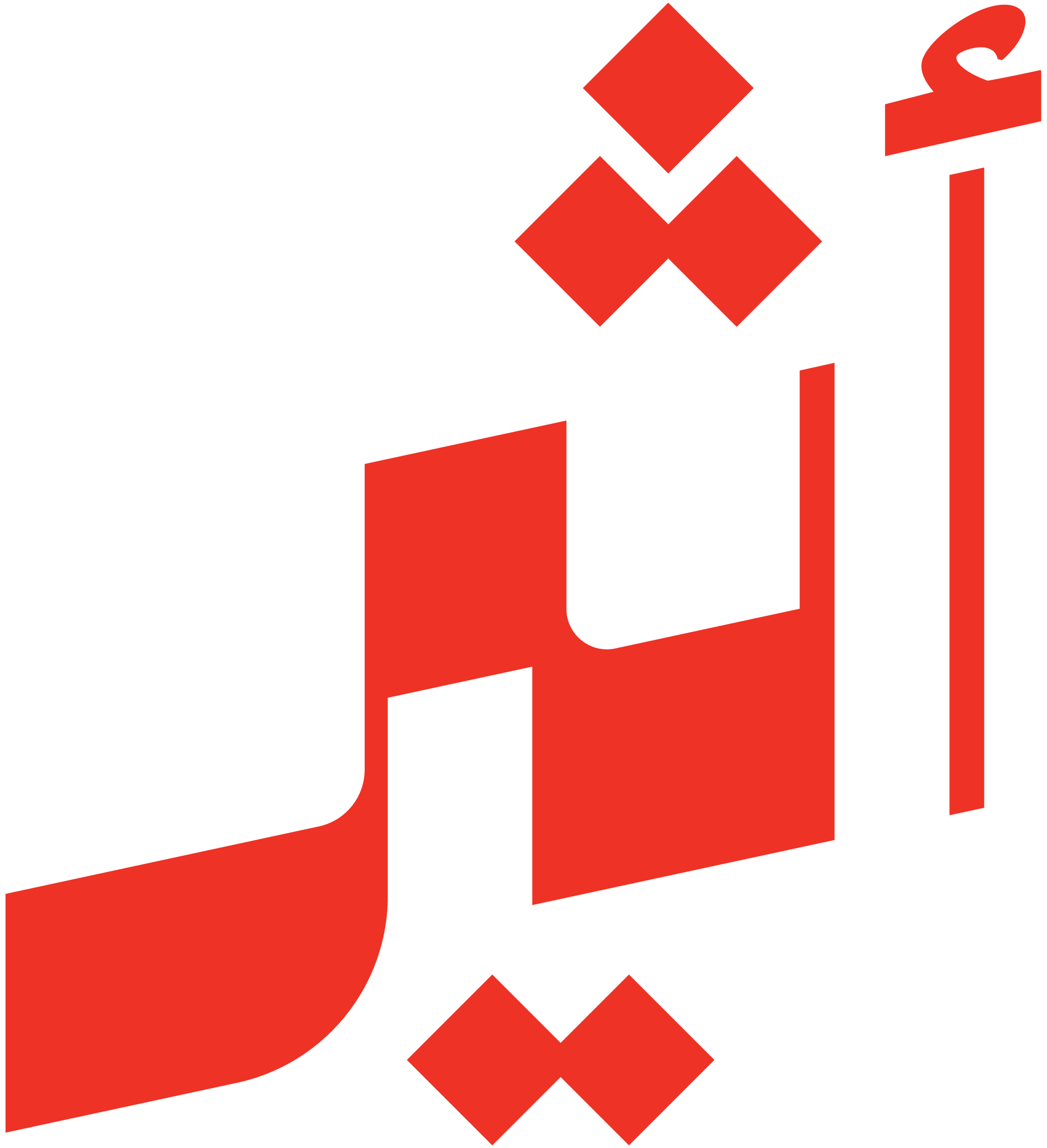مسقط - أثير
إعداد: سيف بن سالم بن عبد الله الهنائي، باحث ماجستير في تخصص القانون الجزائي بجامعة السلطان قابوس
تعد الجرائم من أسوأ الأفعال والسلوكيات التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، حيث تقف عائقًا أمام السعي نحو التقدم والرقي، والحفاظ على المبادئ والقيم الراسخة في المجتمع. كما تضعف وحدة الصف بين أبناء المجتمع، وتثير مشاعر الرهبة والهلع وانعدام الأمان والاطمئنان. وعلى الرغم من هذا الجانب المظلم للجريمة، فإنها تظل ظاهرة اجتماعية لصيقة بالمجتمع، تنبع منه وتحدث فيه؛ فلا وجود لمجتمعٍ خالٍ من الجريمة.
ومن منطلق هذا التأصيل، فرضت مقتضيات العدالة أن تكون هناك حدودٌ للتمييز بين الفعل الذي يعد جريمة، والفعل الذي لا يشكل جريمة. ولهذا، وضع القانون ما يعرف بالأركان العامة للجريمة ضمن الأحكام العامة لقانون الجزاء، والتي لا تعد الجريمة مكتملة إلا بتوافرها. ويمكن القول إن تلك الأركان تعد بمثابة الثوابت العامة لكل الجرائم في الشريعة الجزائية، مع اختلاف المكونات الأساسية لكل ركن من هذه الأركان، فضلاً عن وجود بعض الأركان الخاصة المميزة لبعض الجرائم.
وغني عن البيان أن المعرفة بالأركان العامة للجريمة تُعد من أبجديات العلم بالقانون، وهي ضرورة لكل أفراد المجتمع، حيث يُدرك الفرد من خلالها الحقوق والواجبات المُلقاة على عاتقه تجاه الآخرين، ويكون في مأمن من الوقوع في المحظور أو الخضوع للمساءلة الجنائية. وإيمانًا بتلك الأهمية، يسعى الكاتب من خلال هذا المقال إلى تعريف القارئ الكريم بالأركان العامة للجريمة.
وبدايةً، نُشير إلى أن المشرّع العُماني أخذ بالتقسيم الثنائي للأركان العامة للجريمة، وهما: (الركن المادي والركن المعنوي)، حيث نص في الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الجزاء، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (7/2018)، على الركن المادي في المواد (27 إلى 32)، وفي الفصل الثالث على الركن المعنوي في المواد (33 إلى 36). وسوف نُسلط الضوء على هذه الأركان بشيء من التفصيل على النحو الآتي:
أولاً: الركن المادي
يقصد به المقومات التي تشكل المظهر الخارجي للجريمة وفقًا لأحكام قانون الجزاء العماني، ومن خلاله يوصف الفعل بأنه جريمة قتل أو سرقة أو احتيال أو غيرها من الجرائم. بحيث يكون على شاكلة نشاط ذي طبيعة مادية تدرك بالحواس، ويعرف من خلاله المقصد الإجرامي لدى الجاني. فلا مجال للبحث في نوايا الناس وما يخبئونه في وجدانهم من توجهات إجرامية، إن لم تترجم على أرض الواقع في صورة نشاط يجرمه القانون، حسبما ورد في المادة (27) من قانون الجزاء العُماني:
(يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط مجرم قانونًا بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل).
وفي هذا السياق، يتكون الركن المادي للجريمة من ثلاثة عناصر أساسية، وهي: (السلوك الإجرامي، والنتيجة، والعلاقة السببية). وبيانها على النحو الآتي:
1) السلوك الإجرامي:
يتمثل في النشاط الإجرامي الصادر عن الجاني، والذي من شأنه إحداث تغيير في العالم الخارجي أو في نفسية المعتدى عليه. وقد يتخذ السلوك طابعًا إيجابيًا، من خلال الإتيان بفعل نهى عنه القانون بواسطة حركة عضوية نابعة من إرادة حرة، كأن يُطلق الجاني النار على المجني عليه أو يضربه بعصا، أو يضع يده على مال الغير. كما قد يتخذ طابعًا سلبيًا، من خلال الامتناع عن القيام بما فرضه القانون، كعدم تنفيذ الأحكام القضائية أو الامتناع عن أداء الشهادة أمام جهة قضائية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الوسيلة التي استخدمها الجاني في ارتكاب جريمته ليست ذات أهمية مطلقة، طالما أن النتيجة واحدة. غير أن بعض الوسائل تظهر خطورة إجرامية أكبر، ولهذا شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات إذا اقترن النشاط الجرمي باستخدام وسائل معينة، كما هو الحال في جريمة القتل باستخدام التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة، المنصوص عليها في المادة (302/ج) من قانون الجزاء العماني، حيث جاء فيها:
(يعاقب بالإعدام، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية: … ج- إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة).
2) النتيجة:
تجسد النتيجة الأثر المترتب على السلوك الإجرامي، وتكسب الجريمة وصفها القانوني. فإن كانت النتيجة وفاة إنسان، سُميت الجريمة قتلاً. وإن كان أخذ مال الغير، سُميت سرقة. وتجدر الإشارة إلى أن القانون لا يشترط تحقق النتيجة في كل جريمة، إذ توجد جرائم تقوم فقط على السلوك المجرد، كما في حالات حيازة سلاح بدون ترخيص أو حيازة مواد مخدرة.
3) العلاقة السببية:
تمثل الصلة التي تربط بين النشاط الإجرامي والنتيجة الحاصلة، إذ يجب التثبت من أن النتيجة (كالوفاة أو الاستيلاء على المال) كانت نتيجة مباشرة لفعل الجاني (كإطلاق النار أو أخذ المال)، فلا تسند المسؤولية لشخص عن نتيجة لم تكن وليدة فعله، وهو ما أكدته المادة (28) من قانون الجزاء العُماني.
ثانيًا: الركن المعنوي
يقصد به توافر الإرادة الآثمة والنية الإجرامية لدى الجاني من أجل إحداث نتيجة سيئة، مع العلم بماديات الجريمة. وعلى عكس الركن المادي، فإن هذا الركن يتعلق بشخصية الفاعل لا بنشاطه. ولهذا، يُوصف بأنه الصلة النفسية التي تربط مرتكب الجريمة بالسلوك الإجرامي، ولا بد من وجود إرادة حرة وواعية لدى الجاني لاقتراف الفعل الإجرامي.
وقد أوضح المشرّع ذلك في المادة (33) من قانون الجزاء، حيث نصت على أن:
(الركن المعنوي للجريمة هو العمد في الجرائم المقصودة، والخطأ في الجرائم غير المقصودة، ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل، متى كان هذا الفعل أو الامتناع مجرّمًا قانونًا، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرّمة قانونًا، يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها،…)
وخلاصة القول، إن فهم الأركان العامة للجريمة يُساعد على تحديد مدى قيام المسؤولية الجنائية، ويُعد حجر الزاوية في بناء العدالة الجنائية، تطبيقًا لمبدأ:
“لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص قانوني”.
فمن خلالها يتضح ما إذا كان السلوك يُشكل جريمة، وما طبيعة العقوبة، ومَن هو الشخص المسؤول عنها، وغيرها من الأساسيات التي تضمن حماية الأفراد من المساءلة الجزائية عند غياب أركان الجريمة.
وختامًا، احرص -أيها القارئ الكريم- على تعزيز معرفتك القانونية، حتى تتجنب الوقوع تحت طائلة المسؤولية، فـ ”لا يعد الجهل بالقانون عذرًا”.