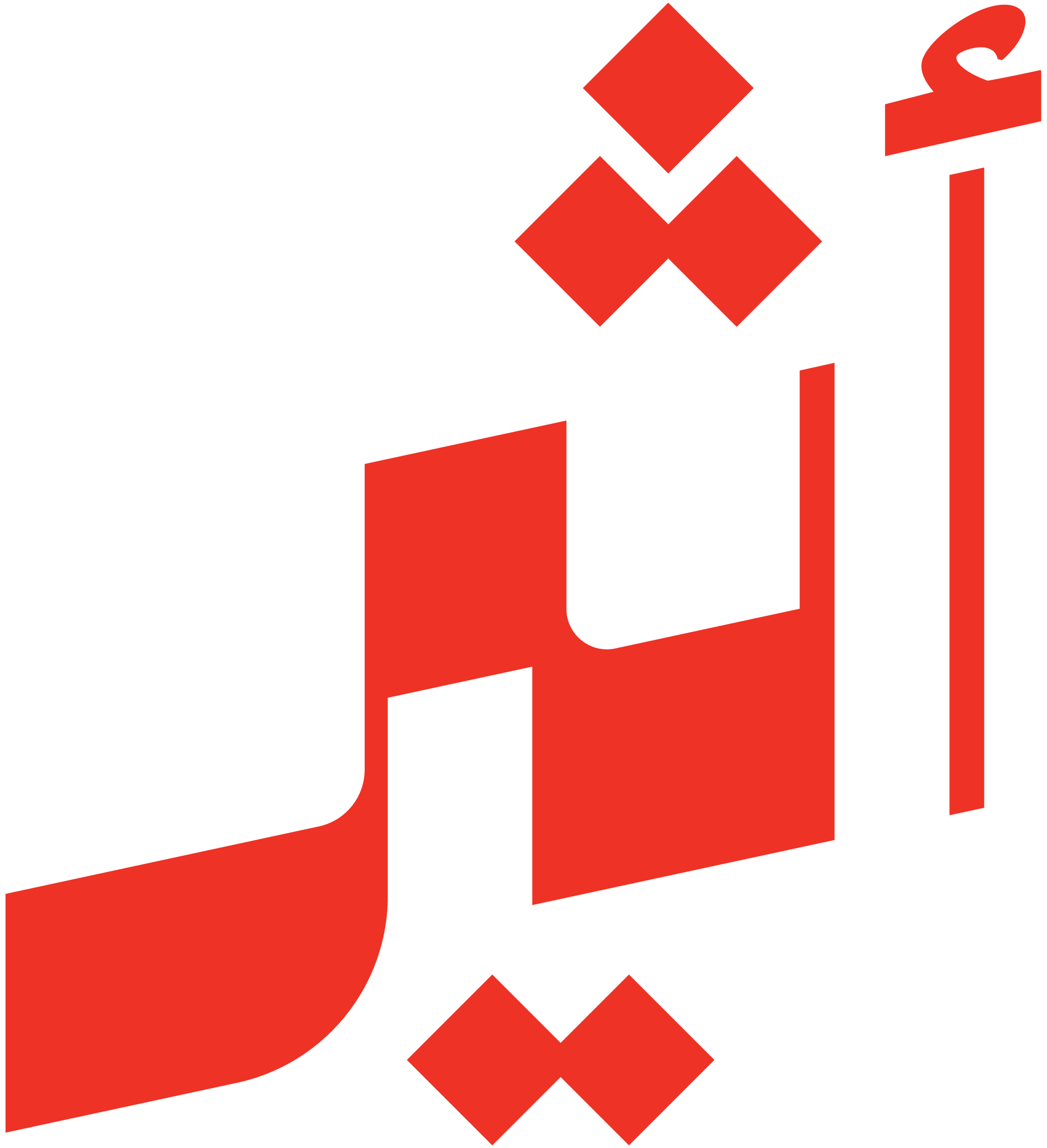محمد حسن - كاتب وباحث سوري
منذ فجر التاريخ، شكّل الطعام مرآة للحضارة. فحين يأكل الإنسان، لا يكتفي بإشباع حاجته، بل يعبّر من خلال المائدة عن طريقته في فهم الحياة. ومن بين أنواع الطعام، احتلّ اللحم مكانة خاصة، لأنه يجمع بين الحياة والموت، بين النار التي تطهّر والدم الذي يرمز إلى القوة.
في الحضارات القديمة، كان اللحم يرتبط بالطقوس الدينية والاجتماعية. عند الإغريق والرومان، كانت الذبائح الحيوانية تقدَّم للآلهة قبل أن يتقاسمها الناس، فيتحوّل الأكل إلى فعل جماعي يربط الأرض بالسماء. وفي المآدب الكبرى، كان اللحم علامة على المكانة والوفرة والسلطة. أما في الشرق القديم، فكانت الولائم التي تُقدَّم فيها الذبائح نوعًا من العهد بين الإنسان والمقدّس.
في فرنسا، لم يفقد اللحم رمزيته، تحوّل مع الوقت إلى طقس وطني يجمع الفرنسيين على مائدة واحدة.شكل “البِفتيك (اللحم المقلي)” أكثر من وجبة؛ وتحول إلى رمز للهوية الفرنسية. هو لقاء الطبيعة بالثقافة، دم يرمز إلى الحياة، ونار تذكّر بالحضارة. والبِِفتيك، إلى جانب البطاطس المقلية، يكون حاضراً في مختلف مناحي الحياة اليومية، بدءاً من الموائد البرجوازية وصولاً إلى وجبات البوهيميين البسيطة، كما يمثل نقطة توازن مثالية بين الاعتبارات الاقتصادية والكفاءة، بين رمزيته الاستهلاكية ومرونته في التقديم، كمن يجمع الطبقات كلها في نكهة واحدة. ورغم أن “الستيك” الأمريكي بات ينافس البِفتيك في الانتشار عالمياً، يظل الأخير كنزاً فرنسياً يثير الحنين لدى الفرنسي المغترب. وتتعزز قيمة الطبق عندما يقترن بالبطاطا المقلية “الفريت”، حيث ينقل إليها بريقه الوطني ليشكلا معاً ثنائياً وطنياً في الوعي الجمعي الفرنسي. حتى إنّ الجنرال الفرنسي دوكاستري أول ما طلب، بعد الهدنة في الحرب الهندية الصينية، طبقاً من البطاطا المقلية، في مشهد رآه الفرنسيون فعلاً رمزياً يدلّ على الارتباط بالهوية الفرنسية.
أما النبيذ فهو روح فرنسا السائلة، الدمَ الرمزيّ الذي يجري في عروقها؛ إنه جزء من ذاكرة الفرنسيين الثقافية. يرتبط لديهم بالاحتفال والفرح والدفء، في الشتاء يدخل في أساطير الدفء، وفي الصيف في أساطير الظل والرطوبة. في الكأس الحمراء تتجسد فكرة فرنسا عن نفسها: بلد يحتفل بالحياة، ويقدّس اللذة بوصفها شكلًا من أشكال الحرية.
على الضفة الأخرى، في العالم الأنغلو-سكسوني، يختلف المشهد تماماً. فالستيك هناك يُقدَّم على طبق منفرد، وكأنه مكافأة للفرد لا احتفال بالجماعة. هو رمز للنجاح الشخصي والإنجاز الفردي، لا للانتماء. وبدلاً من النبيذ، يقف الحليب الأبيض كرمز للنقاء والعقلانية والانضباط، لأسباب اقتصادية وتاريخية،هكذا أخذ الحليب مكان النبيذ في المخيّلة الإنكليزية: برودة تقابل حرارة الجنوب، وفضيلة تضبط اللذة. في فرنسا تُعدّ اللذة حقاً من حقوق الإنسان، أما في إنكلترا فهي خاضعة للقانون الأخلاقي. بين الأحمر والأبيض، بين النبيذ والحليب، يتضح اختلاف جوهري في نظرة الغرب إلى الجسد والحياة.
اليابان القديمة أقامت علاقة أخلاقية وروحية مع اللحم، لا مادّية. فالامتناع عن أكل اللحوم الحمراء، منذ القرن السابع حتى إصلاحات مييجي (1868)، لم يكن ناتجاً عن فقرٍ أو ندرةٍ مادية، بل عن تأثير التعاليم البوذية التي اعتبرت قتل الحيوان فعلاً مدنِّساً. كان اللحم يُستهلك أحياناً في المناطق الجبلية أو لأغراض علاجية تحت أسماء مموّهة مثل yamakujira الحوت الجبلي.
وإذا كانت فرنسا جعلت من اللحم فن للعيش فإن الصحراء العربية جعلت منه فن للبقاء، وصار اللحم معه مرادفاً للكرم والشرف. فاللحم كان أغلى ما يُقدَّم لأن تربية الإبل أو الغنم مكلفة، فذبح واحدة يعني التضحية بجزء من الثروة فمن يذبح ناقةً لضيفه إنما يقدّم له الأمان والمودة، ومنذ تلك اللحظة حضر اللحم على المائدة العربية بوصفه مرادفاً للكرم والهيبة معاً وقدمته الصحراء كقيمة، وأصبحت المائدة جسر لقاء إلى لحظة تذوب فيها الحدود بين المضيف والضيف، بين البيت والعابر، بين الملكية والمشاركة.
وفي عُمان، ظلّ اللحم جزءاً من الحياة اليومية للناس. في الأعياد والمناسبات، حين تُذبح الذبائح وتتصاعد رائحة الشواء في البيوت والساحات، يأكل العمانيون ويستعيدون ذاكرتهم الجماعية حول تاريخ من الكرم والأصالة. في “الشواء العُماني” تُدفن الذبيحة في التنّور تحت التراب لساعات طويلة، لتخرج محمّلة بأريج الأرض وبركتها. الرائحة الزكية التي تملأ المكان ليست مجرد طعام، بل نداء للذاكرة. ومن العادات العُمانية العريقة التي ما تزال حاضرة في بعض المناطق، أن يُترك الضيف ليأكل وحده احتراماً له وتكريماً لذاته وليأكل ما تشتهي نفسه دون خجل، ثم يكسر الضيف الرأس علامة على رضاه عن الضيافة، وبعد أن يطمئن المضيف إلى رضا ضيفه وإشباع حاجته يباشر في الأكل. هذه العادة البسيطة تختصر فلسفة الكرم العُماني: أن تُكرم الضيف بالمودة الصادقة لا بالمباهاة واستعراض العطاء أمامه. فالكرم هنا ليس واجباً اجتماعياً فقط بل قيمة إنسانية تنبع من الإحساس بالآخر.
قال زهير بن أبي سلمى:
تَراهُ إِذا ما جئتهُ مُتَهَلِّلاً
كَأَنَّكَ مُعطيهِ الَّذي أَنتَ سائِلُه
وَلَو لَم يَكُن في كَفِّهِ غَيرُ نَفسِهُ
لَجادَ بِها فَليَتَّقِ اللَّهَ سائِلُه
وكأنّ الشاعر يصف جوهر الضيافة في هذه الأرض الطيبة، حيث العطاء لا يحتاج إلى شاهدٍ ولا ينتظر كلمة شكر، بل يكفيه أن يكون صادقاً ومعه تتحول المائدة إلى رسالة إنسانية تقول أنت جزء منا ونحن جزء منك.
ربما لم يكن اللحم يوماً مجرد طعام، بل وسيلة الإنسان العابرة للزمن ليقول للآخر: “أنا هنا، وأنت لست وحدك”. فالمائدة تنتجُ خطاباً لا يقل تعقيداً عن خطاب السياسة أو الفن. هو الطريقة التي تصنع بها المجتمعات معنىً من الشيء المألوف. فكل لقمة تحمل فكرة، وكل فكرة تسكن جسداً. من طقوس القرابين إلى البِفتيك والشواء العُماني، ظلّ المعنى واحداً: أن نحمي ما هو إنساني فينا من الجوع — لا جوع البطن وحده، وإنما جوع المعنى. وهنا يبدو صوت الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام واضحاً، حين قال: “لا تجعلوا بطونكم مقابرَ للحيوانات.” جملة تختصر المسافة بين الغريزة والرحمة، وتذكّر بأن الأكل ليس فعل شهوة بل فعل وعي واحترام للحياة. فكل مائدة تُقام بصدق هي معجزة صغيرة، تذكّرنا بأن الحياة، مهما اشتدّ لهيبها أو غاب طعمها، تستحق أن تُؤكل ساخنة.